هذا الموقع يشرف عليه مجموعة من .طلبة العلم محبي الدكتور خالد حنفي.
إرسل فتوى
للحصول على فتوى، يرجى ملء هذا النموذج.
للحصول على فتوى، يرجى ملء هذا النموذج.
لقاء مع معلمي اللغة العربية والقرآن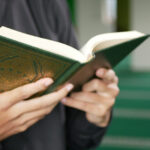
أرحب بالإخوة والأخوات معلمي اللغة العربية والقرآن، وكلامي معكم في عدة نقاط:
أولا/ نظرة نقدية للواقع:
وهذا لا يعني أنه لا توجد إيجابيات، لكن طبيعة مَن يتصدَّى لإصلاح وضع موجود أنه يتجه أكثر إلى الإشكالات والسلبيات حتى يعمل على إصلاحها، فليس مجاله أن يتوقف أكثر مع الأمور الإيجابية الموجودة.
ثانيا/ حلول عملية لعلاج السلبيات:
سنطرح بعض الأفكار العملية لتجاوز هذه السلبيات والإشكاليات، وهذه الأفكار العملية تحتاج إلى نقاش، وحوار، فليس بالضرورة أن ما أطرحه يكون مُسلَّمًا أو منتهَى منه.
ثالثا/ استحضار إشكال الحداثية:
نعيش الآن في هذه المرحلة الزمنية سياقًا حداثيًا بامتياز، والتيار الحداثي سلطانه وسطوته وظهوره إعلاميًا وشبكيًا (على الإنترنت) ظاهر جدًا في هذه الفترة، يطرح أفكارًا تشكيكية في كل الثوابت والقطعيات.
هذه الأفكار، نتيجة عدم نجاح المؤسسات التربوية والدعوية في تحصين الشباب فكريًا، نجحت أن تؤثر في الشباب وتلقى رواجًا؛ فلا بد من استبطان واستحضار هذا الإشكال الحداثي الذي نعيشه.
رابعا / الانفصال عن الواقع الأوربي:
انفصال الوسائل والمناهج التربوية عن الواقع الأوربي؛ هناك اتفاق على أن الوسائل والمناهج التربوية الحديثة، والطرائق الموجودة التي نستعملها في مؤسساتنا التربوية والتعليمية على الساحة الأوروبية، فيها إشكال فيما تنتجه، أنها منفصلة عن الواقع، وعن رعاية التحديات الموجودة التي تواجه الشباب في كل مكان.
أنا عندي حالتان في تركيا لشابَّيْن عربيَّيْن يحفظان القرآن بإجازة أي سند متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
الشاب الأول يا للأسف، سلمنا الله وإياكم وأولادنا وأولاد المسلمين جميعًا، يقول لك: أنا غير مقتنع أن القرآن الذي أحفظه من عند الله سبحانه وتعالى.
فإذا كان القرآن الذي يحفظه، وعاش معه كل هذه السنين وأُجيز فيه، لم ينجح في تحقيق الحد الأدنى بالنسبة له في حفظه هو، فهو نفسه ألحد وبدأ يشكك في القرآن، وهذا معناه وجود خلل، وأن عندنا إشكال يجب أن ننتبه إليه ونرى كيف يمكن أن نتعامل معه.
لو تعاملنا بصراحة مع مَن نعلِّمهم أو نربيهم من الأولاد، وفتحنا بابًا للحوار والنقاش معهم، سنجد أننا نعيش في عالم وهم يعيشون في عالم آخر، وأن القضية بالنسبة لهم أصبحت نمطًا روتينيًا، الهدف منه شَغْلُ الوقت، أو إرضاء الأبوين، لكن هل يحقق ثماره وفوائده؟ لا.
أحد الأئمة عندنا وهو إمام متميز، حاصل على دكتوراه، خطابه إلى حد كبير فيه نوع من التقدم، حكى لي أنه حضر لقاءً مع الشباب وتسلل إليهم بحيث يرى ماذا يقولون وماذا يفعلون؟
كانوا يقومون بعمل مسرحية فكاهية، يعني سمر وترفيه.
فكانت الفقرة موضوعها الأئمة، يمثلون أو يقلِّدون الأئمة في إطار ساخر.
فالشاب الكوميديان الذي يسخر أخذ يقلِّد كل إمام ثم يقول والآن الشيخ فلان وجاء دور تقليد الإمام الذي يحكي لنا القصة، فرآه وقد أخذ يصرخ بصوت مرتفع ويخبط بالعصا، فهذا كان يضحك الشباب أكثر.
فيقول: قعدت أستمع إلى نفسي أو مَن يقلِّدوني على أني أنا هذا الشخص وأقول: يا لها من مصيبة.
يعني معناها أني أنا فاهم أني أحسِن خطيب، وأن خطابي واصل إلى الناس، وأنا بعيد تمامًا عن هذه الصورة.
قد تنتقل أيضًا إلى الأولاد، مدرسة القرآن الكريم في أوروبا هل هي مدرسة تلاحظ الخصوصيات الخاصة بالأطفال الذين وُلدوا وعاشوا في أوروبا، أم هي تستصحب وتستنسخ نفس الطرق ونفس الآليات الموجودة في مدارس القرآن في العالم العربي؟
هذا إذا سلَّمْنا أنه أصلًا طريقة التعامل مع المدارس القرآنية في العالم العربي هي طريقة صحيحة.
أنا أذكر أن الشيخ محمد الغزالي -الله يرحمه- كان يقول: ظللت وأنا كبير، كلما مررت بقول الله تعالى: (وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ) [سورة الإسراء: 13] أتخيل وكأن الإنسان يوم القيامة سيأتي هكذا ومتعلق في رقبته حاجة مثل الحمامة مثلًا أو الطائر!!
لماذا أتى عنده هذا الخاطر؟
لأنه منذ أن حفظ هذه الآية وهو صغير، لم يلفت أحد نظره إلى معنى (وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ) فبدأ يفكر بالعقلية التخيلية التي ارتبطت معه منذ الصغر وثبتت الآية في رأسه بهذا الشكل.
فهل منهجية تحفيظ وتعليم القرآن أصلًا الموجودة في العالم العربي هي منهجية بالضرورة منهجية صحيحة؟
ولو كانت منهجية صحيحة، لماذا لم يؤد حفظ القرآن الكريم إلى الحفاظ على الحد الأدنى على النموذجين اللذين ذكرتهما الآن في تركيا قبل قليل؟
مسابقة قرآنية في ألمانيا
ولذلك لما بدأنا عمل مسابقة قرآنية في ألمانيا، وكانت مسابقة ضخمة مولت بحوالي 70 ألف يورو من أحد الناس، حضرها الشيخ أيمن سويد، وجلسنا نقيّم، شارك فيها آلاف، حوالي 4000 طالب على مستوى ألمانيا، بكل المعايير هي مسابقة ناجحة، وإقبال وكذا.
قلت لهم: أنا أرى أننا نغرِّد خارج السرب، ماشيين بعيد تمامًا.
لماذا؟ قلت: لأن المهاجرين الجدد الذين وصلوا إلى البلد بأولادهم، حفظوا القرآن كاملا في بلادنا العربية، أو نصف القرآن، فدخلوا فحصدوا الجوائز من الأولاد الذين ولدوا في البلد وهم مساكين لغتهم الأم ليست اللغة العربية، فمن يحفظ جزء أو جزئين، كيف يتساوى مع الآخر؟
لأنكم عملتم معيارًا واحدًا سوّى بين الجميع، وهو خرج محبطًا وعنده مشكلة.
شارك ثلاثة أو أربعة من الألمان، الألمان الذين لا يعرفون اللغة العربية، حافظين ثلاثة أجزاء مثلًا، أربعة أجزاء.
الألماني الذي لغته الأم ليست اللغة العربية ولا حتى اللغة غير الأم، لا يعرف شيئا في اللغة العربية، حافظ ثلاثة أجزاء.
أنا تعاملت معه مثل العربي المولود في بلد عربي وأدخلته بالمعايير وظلمته ظلمًا مبينًا من هذا الأمر.
فقلت لهم: المسابقة كل معاييرها يجب أن يُعاد النظر فيها تمامًا، بحيث نراعي الأمور الأوروبية.
والدورة المقبلة يجب أن نغير المستويات ويكون عندنا فرع للتلاوة، واستراتيجيتنا الأساسية في التعامل مع القرآن ليست كم حفظ الأولاد من القرآن.
قالوا: ما الاستراتيجية الأساسية؟
قلت لهم: أولا/ أن يتقن الأولاد الذين ولدوا في أوروبا قراءة القرآن من المصحف.
ثانيا/ أن يحفظوا قدرًا نتفق عليه يكون مثلًا جزءًا أو جزأين، شرط قدر كبير من القرآن، تصح به الصلاة، أغرس به فيه مجموعة من القيم التي أرى أننا بحاجة إليها هنا.
إعادة النظرفي طريقة الحفظ أو أسلوب الحفظ:
دائمًا عندما نحفظ، نبدأ من سورة الناس وهذه السور القصيرة.
لا يوجد قانون يقول لنا لازم نحفظ بهذا الشكل.
لكن لماذا نفضل هذه الطريقة؟
لأنها سور قصيرة يحفظونها بسرعة، وتشعرهم بالإنجاز، أنا حفظت 10 سور، لكنها صعبة جدًا في الفهم وفي المعنى، وممكن تكون صعبة كمان في المصطلحات.
مثل (وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا) سورة العاديات: 1، (فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا) سورة العاديات: 2.
قلت: نغير هذا الكلام ونبدأ مع الأولاد بالقصص القرآني، بحيث أعلم الأولاد القصص الأول، ثم أنقلهم بعدما عرفوا القصة، أنقلهم إلى حفظ السورة التي سمعوا قصتها.
مثلًا، أنا أرى أن قصة سيدنا يوسف عليه السلام قصة مهمة جدًا بالنسبة للمسلمين الذين يعيشون في أوروبا وفيها دروس في غاية الأهمية بالنسبة للمسلمين الذين يعيشون في أوروبا، فآخذ قصة يوسف لأوصل له رسائل من خلالها.
آخذ سورة النمل مثلًا أو مقاطع من سورة النمل مثلًا، لأن أيضًا فيها رسائل مهمة جدًا بالنسبة للمسلمين الذين يعيشون في أوروبا.
آخذ مثلًا سورة الحجرات لأن فيها…..، آخذ سورة النور….، وهكذا.
ونكون بذلك قد غيرنا الفكرة، لأني بدأت أربط الأولاد بالقرآن بشكل صحيح بالنسبة للسن والعمر.
أغير طريقة التحفيظ نفسها الموجودة، والانتقال من الطريقة المعتمدة على التلقين إلى الطرق المحببة للأطفال.
الأطفال يعشقون ثلاث حاجات:
ندخله بالتسابق، نعمل كأن في تسابق بين الأولاد في عملية الحفظ المهم أن نتجاوز مسألة التلقين.
كانت الفكرة ببساطة أن الأستاذ المعلم، معلم القرآن، يأتي بالأولاد ثم السورة أو القصة الذين سيشرحها لهم ويحفظها لهم، يشرح لهم معناها إيه، (وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا)، الخيول والقتال والوهج الخارج منها وكذا، يشرح لهم الآية ويختار الآيات القابلة للرسم والتصوير.
ثم يقول له: أنت وظيفتك في البيت أنك تركِّب لي هذه الآيات على رسوم من عندك أو صور، ممكن أنت تأتي لي بالصور من الإنترنت بحيث أنا أفهم أنك فهمت الآية، لأنه لو وضع صورة غلط، معناه أنه غير فاهم للآية بشكل صحيح.
النتيجة أن البيت كله اشتغل على القرآن، لأن الولد عايز يفهم فيروح لأمه: قولي لي معنى: (الْعَادِيَاتِ ضَبْحًا) ويسأل أبوه، أبوه يفتح التفسير، ليفهم الآية بشكل صحيح، تقول للولد: هي كذا، طيب ما الصورة المناسبة؟
فالآباء قالوا له: أنت عملت ثورة وخدمة جليلة لنا ولأولادنا.
أول مرة أفهم معنى (والْعَادِيَاتِ ضَبْحًا) (فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا)، لأن ابني أكرهني على أني أفهمه وآتي له بصور، والأسرة كلها ساعدته في تركيب الصورة المناسبة للآية، والولد سعيد جدًا أنه نجح في أن يعرف ويأتي بمجموعة من الصور على كل آية من الآيات.
الآن الأستاذ مطمئن تمامًا إلى أن الولد حفظها، وفهمها، ولما يقرأها أو يسمعها، يستصحب المعنى، وبالتالي يقدر أن يتفاعل معها، وبالتالي يقدر يتأثر بالقرآن.
الإشكالات والمخاطر الموجودة:
أرى بالنسبة للأوروبيين أننا نتعامل مع القرآن بصورة خاطئة، أنا لست مقتنعًا أبدًا أن ترجمة معاني القرآن الكريم يمكن أن تقدم فكرة القرآن أو رسالة القرآن للأوروبي غير المسلم.
نحن العرب هل نقرأ القرآن ونفهمه؟
إذا قرأ أحدنا القرآن الكريم مجردًا بدون أن يرجع إلى التفاسير، هل يستطيع أن يأخذ روح الأفكار القرآنية والرسائل القرآنية بشكل كامل دون أن يفهم أو يفسر؟ لا يستطيع.
بالعكس أنا أرى أن الترجمات الموجودة، حرفية النصية الموجزة الموجودة، تكرِّس إشكالًا، لأنه لما يقرأ: (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا)، سورة المائدة: 38.
هل سيقرأ شرح أو فلسفة (فاقطعوا أيديهما؟ ) كيف سيفهم: (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ)، سورة النساء: 11. و (مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ)، سورة النساء: 3.
و(وَاضْرِبُوهُنَّ) سورة النساء: 34.
عندنا في الترجمة الألمانية، أفضل ترجمة ألمانية، طبعة مجمع الملك فهد، متداولة ومشهورة جدًا لأنها مجانية.
كاتبين في التفسير: الضرب، هو كذا تفسيره العادي، ثم في الهامش: والنبي صلى الله عليه وسلم لم يضرب أبدًا، بل نهى عن الضرب وكذا.
ما النتيجة؟ النتيجة أن من سيقرأ سيفهم أن السنة عكس القرآن، أو أن هناك تناقض بين القرآن والسنة، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يخالف القرآن.
كتاب المحاور الخمسة للقرآن الكريم
لو أن كتاب المحاور الخمسة للقرآن الكريم للشيخ الغزالي رحمه الله تُرجم إلى اللغات الأوروبية، سيقدِّم روح الأفكار القرآنية أفضل من ترجمة القرآن الكريم بالشكل الذين موجود فيه.
كيف نتعامل مع القرآن كرسالة إلهية للبشر؟
نتعامل معها في الإطار الموضوعي وليس في إطار الترجمة الحرفية النصية هذه.
بمعنى مثلًا أنا أتخيل لو أن واحدًا غير مسلم أو حتى مسلم حديث، قرأ الآيات التي تتكلم عن الكفار في القرآن الكريم: (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَٰئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ)، سورة البينة: 6. (قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ)، سورة التوبة: 29. الآية.
الفهم الظاهري من خلال الترجمة للنص فيها إشكال لأن الآية لها سياق وتخاطب ناس معينة.
العام قبل الماضي (المحاضرة ألقيت عام 2020) في مجموعة من الكتاب والأدباء والمشاهير في فرنسا وفيهم سياسيون بارزون جدًا، عملوا وثيقة دعوا فيها إلى حذف الآيات المحرِّضة على العنف في القرآن الكريم، حوالي 100 واحد، لعلكم سمعتم بهذا الموضوع.
رئيس الوزراء أيدها، وكانت ضجة وقصة كبيرة جدًا.
يقول: تعالوا يا جماعة وانظروا ماذا يقول القرآن ؟
وأنا كم مرة يأتيني صحافي يقول: هل القرآن الكريم فعلًا فيه: (وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً)، سورة التوبة: 36؟
سأقول له: أكمل (وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً)، سورة التوبة: 36. إذن المشركون هم الذين بدأوا، فأنت ترد على اعتدائهم.
فالحاصل أنه نَزْعُ الآيات عن سياقها، وأن عندنا آية تخاطب كفارًا محاربين، وآية أخرى تفرِّق بين المعاهدين والمسالمين…. إلى آخره، كل هذه الآيات لها منظومة خاصة بها.
فأنا محتاج عندما نتعامل مع ملف المرأة مثلًا في القرآن الكريم، هم يقرأون ملف المرأة في القرآن الكريم على أنه في إطار مثل : (وَاضْرِبُوهُنَّ)، سورة النساء: 34. (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ)، سورة النساء: 11. (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ۖ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ)، سورة البقرة: 282.
هذا ما يعرفونه في القرآن. أربعة أو خمس إشكالات. كل إشكال منهم يغلق تمامًا دائرة النظر في الإسلام كدين.
الحل هو أن ننتقل من هذا الإطار إلى الأطر الأخرى.
لذلك أقول إن المحاور الخمسة تلخص الأهداف العامة للقرآن الكريم، في خمسة محاور أساسية هي كذا وكذا وكذا.
ثم من الممكن أنتقل بعد ذلك إلى القراءة والترجمة والخطوات الأخرى.
إشكالية الخطاب الدعوي بشكل عام
يجب أنه يكون عندنا اتفاق على أن خطابنا الدعوي العام هو الذي يشكل منظومة البيان الدعوي، التي تشمل الخطاب الموجود في المدارس القرآنية والمدارس العربية، وتشمل الخطاب في المساجد والمؤسسات الدعوية، وتشمل خطابنا في بيوتنا وأسرنا مع أولادنا؛ هو خطاب كله إشكالات.
لست ضد الحفظ، لكن لا يكون هو الهدف الأساسي، ثم نأخذ نقارن: أنا ابن أخي في مصر عمره كذا وحافظ القرآن وأنت هنا سنك أكبر منه ومع ذلك ما حفظت.
يا أخي هذا الكلام يحبط الأولاد وهذه مقارنة ظالمة وليست عادلة، لأنك لا تراعي الظروف والخصوصيات الخاصة.
ابنك الذي يعيش هنا وحفظ جزءًا من القرآن، ويستطيع أن يتقن التلاوة بشكل صحيح، لغته الأم شئت أم أبيت ليست هي اللغة العربية، ظروفه ووقته ومهامه الدراسية.
اليوم الذي يقضيه زميله في المرح واللعب يوم العطلة، نحن عندنا في ألمانيا لا يمكن الأساتذة في عطلة نهاية الأسبوع يعطوا واجبات وأعمالًا كثيرة وثقيلة، العطلة عطلة يجب أن تكون عطلة.
طيب العطلة بالنسبة لنا عندك لغة عربية وعندك قرآن وعندك رياضة طيب أين الوقت الذي فيه مساحة للعب مقارنة بزميله؟
فالحمد لله أن الولد صابر، وأموره ماشية.
نقول له: خلي بالك، مقارنةً ابنك بالآخر الذي يعيش في مصر الذي حفظ القرآن ما شاء الله وهو صغير وكذا مقارنة ظالمة.
لست ضد أن يحفظ الأولاد في أوروبا القرآن، والله لو أنا وجدت أن ولدًا فيه نبوغ ومتميز، أدعمه وأساعده، يحفظ نص القرآن، يحفظ القرآن كله.
إنما أنا قضيتي الأساسية الآن هي أن أغير استراتيجية التعامل مع القرآن والأهداف الكلية في التعامل مع المدارس القرآنية على الساحة الأوروبية، بمعنى مثلما قلت يكفيني أن يتقن الولد تلاوة القرآن الكريم من المصحف، يحفظ قدرًا تصح به صلاته، وصلته بالقرآن الكريم، يهتم بالمعاني والـتأثر، وكيف يتفاعل الولد مع القرآن عندما يقرأ القرآن.
أنا محتاج أني أطور العلاقة، علاقة الانتماء، علاقة القرب، التأثر، كيف؟
أنا طرحت مثلًا تجربة الرسم، تجربة الكلام الموجود، وإذا في أفكار أوروبية أخرى عندها تجارب أخرى ناجحة، ندرس هذه التجارب كيف هي وكيف يمكن أن نطورها أكثر ونستفيد منها أكثر.
أنا غير متخصص في تعليم القرآن الكريم للأولاد لا الكبار ولا الصغار ولا مارست هذا العمل، لكن أنا أنظر إلى أولادي وأنظر إلى المجتمع الموجود، والتجربة التي تمت معي أنا شخصيًا لما حفظت القرآن، ولو عاد بي الزمان إلى الوراء لأحفظ القرآن فلن أحفظه بهذا الشكل الذين نحن حفظناه به، لأنها طريقة تفصلك تمامًا عن المعنى، وعن التأثر، وعن التعايش، وليس لهذا أنزل القرآن الكريم.
كل علل التعامل مع القرآن الكريم الموجودة الآن، جزء منها موروث، وقد ذكرت نموذج الشيخ الغزالي الآن وهو ذكر إشكالًا آخر مثلًا، لما كبر صار وراح التعليم الأزهري مثلًا ورأى أنهم في التعليم الأزهري يركِّزون على الجوانب اللغوية في الآيات وكذا وكذا، بعد يشرح أول سورة هود، وأين مرجع الضمير، والتفسير، والإعراب، وكذا.
قال: هذا الكلام كله مهم وممتع، أنا كنت أستمتع بيه، لكنه فصلني عن روح الآية وعن جوهر معناها وعن أني أتعايش معها وأتأثر بها وأتفاعل معها إلى آخره.
لو أردت أن ألخِّص سمات الخطاب بشكل عام بما فيه المدارس القرآنية والعربية في الإطار النقدي سألخصه في الآتي:
السمة الأولى أنه خطاب عربي:
ولا أقصد بعربي أنه عربي اللغة فقط، لا، عربي الوجهة، والمضمون، وطريقة الطرح والتناول، لا يستصحب الخلفيات الأوروبية التي نحن موجودين فيها.
وبالتالي النتيجة التي نصل إليها أمام هذه السمات كلها هي حالة الانفصال، نجد أنفسنا هم يعيشون في عالم وأولادنا يعيشون في عالم، يستغربون كل الأفكار التي نطرحها.
نحن غير قادرين أن نستوعب أولادنا مستغربين ليه، وهم غير قادرين أن يستوعبوا لماذا نحن متضايقين، ونبقى في هذه الدائرة المغلقة لا نخرج منها.
الإشكال أنه الذي يضاعف الأمر أن الولد سيجد هذا الكلام في البيت، ولما يذهب للمدرسة أو في المسجد يجد شيئا متغيرا، النتيجة أنه سيفر من البيت وينفر من المدرسة العربية والمسجد، ويبحث عن الأطر الأخرى التي يعالج بها النقص الموجود.
السمة الثانية: أن هذا الخطاب هو خطاب ماضوي:
دائمًا ينزع إلى الماضي، يحاول أن يرجع إلى الماضي. الرجوع إلى الماضي ليس خطأ في حد ذاته، لكن المشكلة في البقاء فيه، واعتباره هو النموذج، وعدم الانتقال.
نحن تكلمنا عن الماضي، عدم الانتقال من الماضي إلى الحاضر إلى المستقبل.
إمام أوغلو الذي فاز برئاسة بلدية إسطنبول مؤخرًا وهزم أكرم، إمام أوغلو، فاز على علي بن يلدريم الذي هو رئيس الوزراء التركي بتاريخه وحزب عنده إنجازات وكذا وكذا.
سألت بعض الشباب في إسطنبول: ما السبب؟ قالوا من التحليلات المهمة جدًا في هذا الموضوع: أولًا عمر الأول وعمر الثاني، ماشي.
واحد في الأربعينات مثلًا شاب، والثاني يقترب من الستين،
اثنين: الخطاب. أن خطاب علي كان دائمًا يرجع إلى الماضي، يقول: أنتم ما تعرفوا إسطنبول كيف كانت وكيف صارت.
هو كلامه صحيح، لكن الشباب الجيل الجديد يقول: نحن ما رأينا ذلك الماضي إنما نحن رأيناها الآن.
فتكلم عن الماضي والحاضر، ولم يتكلم عن المستقبل.
أنا أعدكم أن إسطنبول ستكون كذا وكذا. وهو كله برامج كلام خلي بالكم، ما حقق أي شيء منها حتى الآن، لكنه نجح بهذا الخطاب أن يستقطب الشباب ويُطمئنهم ويؤثر فيهم وإلى آخره.
السمة الثالثة أنه خطاب مثالي جدًا وغير واقعي:
يعني أنا يجب أن أنا لما أطرح خطابًا أو طلبات من أولادي أو من المسلمين في المجتمع الذي أنا فيه، أن أكون واقعيًا.
ممكن أطلب حاجة مثالية جدًا، عايز ابني يكون كذا أنا أريدك أن تكون الأول. وهذه من الآفات التربوية الموجودة عندنا، لازم تكون الأول، ماذا لو كنت الثاني، أو الثالث الرابع الخامس؟
أنا عندي ملكات معينة ضعيف فيها. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يراعي القدرات، المستويات الفردية، والفرق بينها، الفروق الفردية بين الناس.
في واحد متميز في شيء، وفي واحد ضعيف، واحد قدراته العقلية ضعيفة، ما يقدر أن يكون الأول ولا يتفوق في الدراسة أصلًا.
فأنا لا بد أن أكون واقعيًا، وهذه الواقعية مطلوبة أيضًا في الالتزام والتدين، وفي التعليم.
الواقعية مطلوبة في التعليم، أنا عايز لازم الولد يحفظ. طيب هو ليس عنده قدرات ليحفظ، غير قادر.
أنا كثيرًا أتخيل مثلًا، أقول: لو أنا كعربي ما أعرف اللغة الصينية مثلًا، ثم جاء لي واحد قال لي: أنت لازم كل أسبوع تحفظ هذه الصفحة بالصيني ردد ورائي ردد نحن نفعل هكذا في القرآن؟
كل سورة في القرآن الكريم لها مفتاح:
عملت حلقة مع مجموعة من الشباب الذين وُلدوا في ألمانيا، بعضهم يعرف لغة عربية، بعضهم ما يعرف.
فكانت الحلقة أني أقول لهم أن كل سورة في القرآن الكريم لها مفتاح، لو قدرنا نصل للمفتاح، والمفتاح عنده ارتباط باسم السورة، وقدرنا نوصل للمفتاح ونفتح السورة، سنفهمها وسنفهم كل آية فيها.
تمام؟ ثم عملت لهم تجربة في هذا الموضوع وأعطيتهم المفتاح ونموذج، ثم قلت لهم: أنتم اشتغلوا، طلعوا لي بقية النماذج الموجودة في كانوا سعداء جدًا وفرحانين ومتفاعلين، وبدل المحاضرة ساعة دخلت على ثلاث ساعات وكذا وكذا، لأنهم بدأوا يفهمون فلا بد أن ننتقل بالخطاب من المثالية إلى الواقعية.
حتى في طلب التدين، ومعيار التدين. أنا محتاج ابني كيف يكون في مثل التزامي وتديني، لا أطلب المثالية فأفقد كل شيء.
أنا عندي أحد الآباء وهو إمام، ابنه حلق حلقة غريبة يقلد فيها فنان أو مغني، حلقة غريبة بالنسبة للحيته وشعره، شكله غريب.
فـأبوه لم يعجبه الكلام، أنت احلق أنت اعمل كذا. فـرفض الولد. ضغط عليه: إذا لم تفعل سأطردك من البيت.
الولد عاند فطرده من البيت. واتخذ صديقًا، وشرب الخمر، وترك الصلاة….
وقعدت معه عملت معه برنامج، وشيئًا فشيئًا بدأ حتى انتهى به الأمر إلى أنه سافر لبلد عربي يدرس العلوم الشرعية وحفظ القرآن.
فالمشكلة في طريقة التعامل مع الإشكالية، لأنه أبوه نظر إلى الزمن الذي هو عاش فيه نظرة مثالية ليست واقعية.
أي نعم هذه الصورة غير مقبولة، لكن لا ندفعه بالخطأ إلى ما هو أقبح وأسوأ منها مثلما حصل.
السمة الرابعة أن الخطاب الديني خطاب عاطفي:
دائمًا يلهب المشاعر والأحاسيس، ولا يأخذ الناس إلى هدف معين أو إلى خطوات عملية.
السمة الخامسة أن الخطاب الديني خطاب ممل:
ممل لأنه يتكرر دائمًا ويكرر الأشياء في المناسبات المختلفة.
في كتاب طيب جدًا للدكتور عبد الكريم بكار اسمه (كيف نفهم الأشياء من حولنا)، شيء في هذا. فتكلم عن كيف نفهم الأشياء.
من الأشياء التي ذكرها، قال إن طبيعة الأشياء أنه كلما تكررت على الإنسان يمل، حتى لو كانت مهمة.
ضرب مثالًا على هذا بالحديث الذي يجري على ألسنة الخطباء في كل جمعة: “تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدًا: كتاب الله وسنتي”. تمام؟ وحديث لرسول صلى الله عليه وسلم ومهم كل شيء، لكن الأذن كل ما يتكرر عليها خلاص تبدأ تقفل.
المقصود أن أقدم نفس المضمون لكن بأسلوب آخر، برواية أخرى.
عملنا الكتب الستة كلها مع الشيخ أيمن سويد -الله يحفظه- قعدنا نقرأها. يعني أخذنا البخاري في 20 يوم ومسلم في 20 يوم، بقية الكتب كل كتاب في 10 أيام، نجلس في مكان، كل يوم ثمان ساعات نقرأ بالسند المتصل للنبي صلى الله عليه وسلم.
أنا كنت واحدًا من الناس المعارضين جدًا لفكرة هذه الدورة في الأول، لكن بعد ما جربت الأمر عمليًا، تحمست بل صرت من أكثر المتحمسين لهذا المشروع. لماذا؟ لأنه أفاد جدًا.
ومن ضمن الفوائد العلمية، فضلًا عن الفوائد الروحية، معنى أنك تتصل بالرسول صلى الله عليه وسلم.
أحد الأساتذة عبَّر تعبيرًا لطيفًا ورائعًا جدًا قال: أنا قبل هذه الدورة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هنا. بعدها صار هنا. يعني انتقل من العقل إلى القلب.
ماذا حدث؟ نحن اطلعنا على روايات كثيرة وأحاديث كثيرة لم نكن قد اطلعنا عليها من قبل.
فلما أعالج قضية ما، أتحدث بالحديث المحفوظ والمألوف بالنسبة للناس، ولذلك أنا أقوم على كتاب إن شاء الله في المراحل الأخيرة اسمه: (الأربعون حديثًا الأوروبية) يعني 40 حديثًا للمسلم المقيم في الغرب أو لغير المسلم يقرأها، يأخذ فكرة عامة عن الإسلام والأحاديث هي بنفسها ترد له عن شبهات، تعالج إشكالات بشكل غير مباشر.
فهذه هذه الدورة جعلتنا نطلع على آلاف الأحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم.
السمة السادسة أن الخطاب الديني غير علمي:
بمعنى أنه لا يعتمد على الدراسات العلمية.
نحن كمسلمين عاطفيون، بالذات في ملف الإعجاز العلمي، نلتقطها والله أكبر وهذا الكلام ممكن أن يكون مناسبا لنا، لكن لأولادنا الذين وُلدوا هنا؟ كلا، سيقول لك: أين الدراسة؟ ويبحث ويسأل .
بعض الباحثين المهتمين بظاهرة الإلحاد في مصر، قال: إن من أسباب الإلحاد، هو الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية.
قلت له: كيف؟ قال لي: لأنه صار بوابة للتشكيك.
هو يقول إن الإسلام قال كذا وسبق إليه قبل آلاف السنين، وهذه الحقيقة أشار إليها القرآن في كذا وفي السنة النبوية.
ثم لما يدرس هذا الكلام إذا به غير صحيح.
وأحد الإخوة الباحثين قال لي: أنا أول ما الإمام على المنبر يقول: أثبتت الدراسات العلمية، أسد أذني قلت له: لماذا ؟ قال لي: لأن في كارثة أكيد ستأتي في كلامه.
يعني قول الإمام أثبتت الدراسات العلمية فالمعنى أنه سيقول أي حاجة وما في دراسات علمية ولا يحزنون.
فأصبح الإعجاز العلمي أداة لإثبات التخلف الحضاري للأمة، مع أننا نريد أن نثبت أننا سابقين به.
المهم أن الخطاب يجب أن يكون خطابًا علميًا، وقبل أن نقول في دراسات علمية تقول كذا، نستوثق منها ونسأل أهل الخبرة.
لكن إذا لم يكن عندنا بحث علمي دقيق نسكت.
الذبح الحلال، ومسألة التخدير:
الآن نتحدث عن الذبح الحلال، ومسألة التخدير وما يتعلق بها.
فهل توجد دراسات موثقة أُجريت حول موضوع الذبح من دون تخدير والذبح مع التخدير، أجراها باحثون مسلمون؟
نعم، هناك دراسات، لكنها لم يقم بها مسلمون، بل باحثون بيطريون غير مسلمين.
هؤلاء أجروا مقارنة بين الذبح بالتخدير وفق الطريقة الأوروبية، والذبح من دون تخدير وفق الطريقة الإسلامية، وانتهوا إلى أن الطريقة الأصح للإنسان والأرفق بالحيوان هي الذبح الخالي من التخدير.
وهناك بالفعل دراسات علمية اطّلعت عليها، لكنها تحتاج إلى مزيد من التوثيق وإلى مؤسسات إسلامية تتبناها وتقوم عليها.
وإلا فالنتيجة السائدة اليوم أنّ الطريقة الأوروبية تبدو أرفق بالحيوان، حتى إنّ الشيخ محمد عبده، وتبعه الشيخ يوسف القرضاوي، ذهبا إلى أنّ الطريقة الأوروبية في الذبح أرفق بالحيوان من الطريقة الإسلامية.
لكن الحقيقة أنّ عملية التخدير ليست سوى وسيلة لإخضاع الحيوان وتسكينه، وهي في ذاتها تُعرّض الحيوان للألم، بل وقد تؤدي إلى موته قبل الذبح.
وهناك واقعة مشهورة في المحكمة: رفع أحد المسلمين قضية يطالب بالسماح له بالذبح من دون تخدير، فاحتجّت الحكومة بأنّ التخدير لا يؤدي إلى موت الحيوان.
فقضت المحكمة بإجراء تجربة عملية، فجُرّب عجلٌ بالمسدس الكهربائي فسقط على الأرض. فقالوا: انتظروا سيقوم بعد قليل. مضت ساعة وساعتان وثلاث ولم يقم أمام المحكمة نفسها، فحكمت له المحكمة بالسماح بالذبح من دون تخدير، لكن بترخيص خاص له وحده، لا لجميع المسلمين.
فالخلاصة أنّ الخطاب في هذه المسألة يحتاج إلى تأصيل علمي دقيق، وإلى ترتيب الأولويات، إذ إنّ كثيرًا من الطرح المتداول اليوم يفتقد إلى هذا الترتيب.
أولويات ترتيب الخطاب الديني